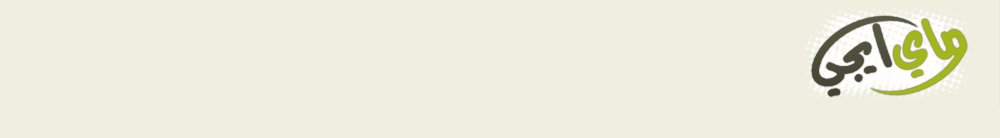(1)
ليس من مهمة هذا البحث متابعة المعطيات الفقهية الخصبة والمتميزة بصدد التعامل مع الآخر، وإنما التأشير على بعض الممارسات التاريخية كشواهد فحسب، من بين سيل من الوقائع لا يكاد يحصيها عدّ، تؤكد فيما لا يدع أي مجال للشك في أن النصارى واليهود من أهل الكتاب، وغيرهما من الفرق الدينية الأخرى، عاشوا حياتهم، ومارسوا حقوقهم الدينية والمدنية على مداها في ديار الإسلام، فيما لم تشهده ولن تشهده أية تجربة تاريخية في العالم.
إن التاريخ هو الحكم الفصل في قدرة المذاهب والأديان على التماسّ مع الواقع، وتحويل "الكلمة" إلى فعل منظور.
ابتداءً.. ما الذي أرادت التأسيسات القرآنية أن تقوله فانعكس ـ بالتالي ـ في نسيج الفعل التاريخي بين المسلم وغير المسلم؟
إن التغاير والاختلاف قائمان في صميم العلاقات البشرية، والتوحّد في وجوهه كافة لا ينفي التغاير، كما أن هذا لا ينفي التوحّد، إنهما يتداخلان ويتوازيان ويؤثر أحدهما في الآخر، بل قد يرفده بعناصر القوة والخصب والنماء.
قد تحدث حالات تقاطع تقود أحياناً إلى النفي والتعارض، لكن الخط الأكثر عمقاً وامتداداً هو أن التجربة البشرية من لحظات تشكلها الأولى وحتى يقوم الحساب، إنما هي تجربة تتعدد فيها الانتماءات وتتغير العلاقات وتتنوع القناعات، وأن هذا التغاير في حدوده المعقولة، ومن خلال تعامله مع الثوابت التوحيدية، هو الذي يمنح التاريخ البشري، ليس فقط تفرده وخصوصيته، وإنما قدرته على الفعل والصيرورة.
في المنظور القرآني يبدو التنوع مستقطباً عبر مجراه الطويل بكلمتي الإيمان والكفر، أو الحق والباطل، ترفده جداول وأنهار متشابكة تجيء من هذا الصوب أو ذاك، ومن خلال هذا التغاير تتحرك مياه التاريخ فلا تركد ولا تأسن، وتحفظ بهذا قدرتها على التدفق والنقاء.
إن الإرادة الحرة والاختيار المفتوح اللذين مُنحا للإنسان فرداً وجماعة، للانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك، يقودان بالضرورة إلى عدم توحد البشرية وتحوّلها إلى معسكر واحد.. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها المبدعة تكمن في هذا التغاير، وإن حكمة الله سبحانه شاءت ـ حتى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد ـ أن تشهد انقساماً وتغايراً وتنوّعاً وصراعاً.
والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا التغاير في أكثر من صورة ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً: " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات" [المائدة : 48] ، " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم " [هود: 118ـ 119] ، " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ..."[البقرة: من الآية 253]، "...ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد" [البقرة:من الآية 253].
بل إن القرآن انطلاقاً من منظوره الواقعي لحركة التاريخ البشري يبين في أكثر من موضع أن (الأكثريات) البشرية تقف دائماً بمواجهة الحق الذي لا تنتمي إليه إلاّ القلة الطليعية الرائدة، نظراً لما يتطلبه هذا الانتماء من جهد وتضحية وعطاء لا يحتملها الكثيرون: "بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون" [المؤمنون: 70].
وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان، الذي يعقبه تغاير الثقافات وتعدد الأعراق، أحد العوامل الأساسية التي تكمن وراء التنوع التاريخي الذي هو بحد ذاته صيغة من صيغ الإبداع الإلهي في العالم: " ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم إذا أنتم بشر تنتشرون" [الروم:20].
"ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" [الروم : 22].
أما عن الهدف من وراء هذا التغاير فإن القرآن يجيب: (...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين" [البقرة: 251] " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" [الحج: 40].
تلك هي الأمور الأساسية، إن هذا التغاير والتدافع المركوز في جبلة بني آدم يقود إلى (تحريك) الحياة نحو الأحسن، وتخطي مواقع السكون والفساد، ومنح القدرة للقوى الإنسانية الراشدة كي تشد عزائمها قبالة التحديات، وأن تسعى لتحقيق المجتمع المؤمن الذي ينفذ أمر الله وكلمته في العالم.
وثمة آيات أخرى تبين كيف أن هذا التغاير الذي يعقب تدافعاً وصراعاً إنما هو ميدان حيوي للكشف عن مواقف الجماعة البشرية، والتعرف على أصالة المؤمنين , ففي جحيم القتال، وعلى وهجه المضيء يتضح الذهب من التراب، ويتميز الطيب من الخبيث، وتتحول التجربة إلى منخال كبير يسقط، وهو يتحرك يميناً وشمالاً، كل الضعفة والمنافقين والعاجزين والمتردّدين في مواصلة الحركة صوب المصير المرسوم: " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم " [محمد: 31] ، "ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون". [الأنفال: 37].
وما أكثر ما يتساءل الإنسان عن الحكمة من التقاتل، وما أكثر ما تخيل الفلاسفة والمفكرون عالماً لا يشهد قتالاً ولا تُسفك في ساحته الدماء، ولكن هيهات ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشري المتغاير المتنوع. ولا يزال الصراع أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والفساد: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون" [البقرة: 216].
إلا أن القرآن ـ وهو يتحدث عن الصراع الناجم عن التغاير البشري في المذاهب والأجناس واللغات والمصالح والبيئات الجغرافية ـ لا يقصر المسألة على التقاتل والتدافع، إنما يمدها إلى ساحة أوسع، ويعطي للتغاير البشري آفاقاً بعيدة المدى، تبدأ بإشهار السلاح، وتمتد لكي تصل إلى الموقف الأكثر إيجابية، والذي يجعل هذا التغاير سبباً لعلاقات إنسانية متبادلة بين الأمم والأقوام والشعوب للتقارب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل منها على مذهبه أو جنسه أو لونه أو لغته أو بيئته الجغرافية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم، إن الله عليم خبير" [الحجرات: 13].
(2)
وجاء تاريخنا الإسلامي لكي يمنح مساحة واسعة للتغاير، وقبول الآخر، والتحاور معه.. والوقائع في هذا السياق كثيفة جداً ،ولذا سنكتفي بالتأشير على بعضها.
فمنذ بدايات مبكرة قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة، يهوداً ونصارى، موقفاً منفتحاً رسمت من خلاله تقاليد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ووُضعت أصولها ونُظّمت صيغها، وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية مضت معها هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل في مجرى العلاقات الاجتماعية، وما حدث بين الحين والحين من خروج عليها , فإنه لم يتجاوز أن يكون شذوذاً على القاعدة ازدادت تأكيداً بمرور الأيام.
ما الذي أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقوله وينفذه إزاء غير المسلمين من أهل الكتاب؟ إن بمقدور القارئ أن يرجع إلى كتب السيرة للعثور على الجواب الشامل بجزئياته وتفاصيله(1)، ولكننا نود أن نشير مجرد إشارة إلى العهد الذي كتبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أعقاب غزوة تبوك عام 9 هـ لنصارى نجران، ذلك العهد الذي يمثل قمة من قمم العدل والسماحة والحرية، والذي لم يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة، وقد جاء فيه: " ولنجران وحاشيتهم جوار الله ... ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين... ولا يُؤاخذ أحد منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي - صلى الله عليه وسلم- أبداً، حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم"(2)، وقد دخل يهود نجران في هذا الصلح(3).
كما نود أن نشير إلى العهود التي كتبها لعدد من التجمعات اليهودية في شمال الجزيرة ، بعد غزوة خيبر ( 7 هـ ) والسنين التي تلتها؛ إذ بعث إلى بني جنبة بمقنة القريبة من أيلة على خليج العقبة: "أما بعد، فقد نزل علي رسلكم راجعين إلى قريتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله، وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم، لا ظلم عليكم ولا عدى، وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه.. وإن عليكم ريع ما أخرجت نخلكم وصادت عروككم (مراكبكم) واغتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة، فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم، وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله...". وكتب لجماعة أخرى من اليهود تدعى (بني غاديا): "... إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء"، كما كتب لبني عريض كتاباً آخر يحدد فيه ما عليهم أن يدفعوا للمسلمين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلمهم إياهم(4).
وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود: "إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين، ومن لجأ إليه من المسلمين"(5).
وبذلك تمكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من تحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات من المواطنين في الدولة الإسلامية يدفعون لها ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية، ويحتمون بقوتها وسلطانها، ويتمتعون بعدلها وسماحتها.
ولقد ظل اليهود ـ والنصارى بطبيعة الحال ـ كمواطنين وليسوا كتلاً سياسية أو عسكرية ـ يمارسون حقوقهم في إطار الدولة الإسلامية لا يمسسهم أحد بسوء، وعاد بعضهم إلى المدينة، بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام , وفي مغازي الواقدي.
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يعامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح، حتى إنه أوصى عامله معاذ بن جبل: "بأن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم"، وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين؛ إذ لم يُكلّفوا إلا بدفع الجزية، وبقوا متمسكين بدين آبائهم(6).
وجاء الراشدون لكي يشهد المجتمع الإسلامي تنفيذاً في العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم لا يقل تفرداً وتألقاً عما شهده عصر الرسالة , فلقد كان العصر الجديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت مساحات واسعة من الأراضي التي بلغها الإسلام تضم حشوداً كبيرة من اليهود والنصارى والمجوس والطوائف الدينية الأخرى.
لقد أصبح المجتمع الإسلامي بحركة الفتح هذه مجتمعاً عالمياً ضم جناحيه على أعداد كبيرة من الأجناس والأديان والأقوام والجماعات والمذاهب والفرق والاتجاهات، ونريد أن نعرف كيف تم التعامل معها عبر عمليات الفتح أولاً، وبعد استقرار الوجود الإسلامي ثانياً، وهل تمكن المسلمون من الاستجابة لتحديات التنوع المذهبي في جتمعهم العالمي الجديد؟
يقول السير (توماس أرنولد) الذي سنعتمد على عدد من شهاداته بهذا الصدد في كتابه المعروف: (الدعوة إلى الإسلام The Preaching to Islam) الذي يتضمن تحليلاً مدعماً بالوثائق والنصوص للصيغ الإنسانية التي اتبعها الإسلام في تعامله مع أبناء المذاهب الأخرى.
" ... لما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة "أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم"، وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: "فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا".
ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر: لما حشد الإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين كان لزاماً على المسلمين-نتيجة لما حدث- أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم , فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم أن يردوا عليه ما جُبي من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: " إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله عليهم"، وبذلك رُدّت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: "ردكم الله علينا ونصركم عليهم ـ أي على الروم ـ فلو كانوا هم لم يردوا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا"(7).
" يكشف تاريخ النساطرة عن نهضة رائعة في الحياة الدينية , وعن نواحي نشاطهم منذ أن صاروا رعية للمسلمين. وكان أكاسرة الفرس يدللون هذه الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرى؛ إذ كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون في ولايات هؤلاء الأكاسرة، بل مرّوا بحياة أشد من هذه خطورة، وخضعوا لمعاملة خشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس وبيزنطة عرضة لشك الفرس فيهم، بأنهم كانوا يمالئون أعداءهم من المسيحيين.
ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفاء قد مكنهم من أن يسيروا قدماً في سبيل أعمالهم التبشيرية في الخارج، فأرسلوا البعوث الدينية إلى الصين والهند، وارتقى كل منهم إلى مرتبة المطرانية في القرن الثامن الميلادي.
وفي العصر نفسه تقريباً رسخت أقدامهم في مصر، ثم أشاعوا فيما بعد العقيدة المسيحية في آسيا، حتى إذا جاء القرن الحادي عشر كانوا قد جذبوا عدداً كبيراً ممن اعتنقوا المسيحية من بين التتار.
وإذا كانت الطوائف المسيحية الأخرى قد أخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي، فليس هذا الإخفاق خطأ المسلمين؛ إذ كانت الحكومة المركزية العليا تتسامح مع جميعهم على السواء، وكانت فضلاً عن ذلك تصدهم عن أن يضطهد بعضهم بعضاً.
وفي القرن الخامس الميلادي كان (برصوما)، وهو أسقف نسطوري، قد أغرى ملك الفرس بأن يدبر اضطهاداً عنيفاً للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بإظهار نسطور بمظهر الصديق للفرس، وإظهار مبادئه بأنها أكثر ميلاً إلى مبادئهم.
" ويُقال: إن عدداً يبلغ (7800) من رجال الكنيسة الأرثوذكسية مع عدد ضخم من العلمانيين، قد ذُبحوا في هذا الاضطهاد. وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للأرثوذكس بعد أن غزا هرقل بلاد فارس، وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع الملك بأن الأرثوذكس سوف يظهرون بمظهر العطف والميل إلى البيزنطيين.
ولكن مبادئ المسلمين على خلاف غيرهم؛ إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهداً في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس.
مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس كنائسهم، ولكن المسلمين أعادوها أخيراً إلى أصحابها الشرعيين بعد أن دلل الأرثوذكس على ملكيتهم لها" ( .
.
"ومما يدل على أن تحوّل المسيحيين إلى الإسلام ـ في مصر ـ لم يكن راجعاً إلى الاضطهاد، ما وقفنا عليه من الشواهد التاريخية الأصلية، وهو أنه في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطريركية تمتع المسيحيون بالحرية التامة في إقامة شعائرهم، وسُمح لهم بإعادة بناء كنائسهم، بل ببناء كنائس جديدة، وتخلّصوا من القيود التي حتمت عليهم أن يركبوا الحمير والبغال، وحوكموا في محاكمهم الخاصة، على حين أُعفي الرهبان من دفع الجزية , ومُنحوا امتيازات معينة"(9).
(3)
وما هي إلا لمحات فحسب مما تحدّث عنه توماس أرنولد فأطال الحديث، ولن تغني الشواهد هنا عن متابعة هذا الكتاب ـ الوثيقة ـ الذي يجيء على يد باحث يحترم العلم بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخنا إلا نادراً(10).
ما الذي كان يحدث في المجتمعات الأخرى بين أبناء الدين الغالب وبين المنتمين للأديان والمذاهب الأقل انتشاراً؟يقول غوستاف لوبون: "لقد أُكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي.
وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن , وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات، وكانت مصر، التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد الحكام، تحقد على سادتها الروم، وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين"(11).
ويقول الندوي: "ثارت حول الديانة النصرانية , وفي صميمها مجادلات كلامية شغلت فكر الأمة واستهلكت ذكاءها , وتحولت في كثير من الأحيان إلى حروب دامية، وقتل وتدمير وتعذيب ، وإغارة وانتهاب واغتيال، وحوّلت المدارس والكنائس والبيوت إلى معسكرات دينية تتنافس، وأقحمت البلاد في حرب أهلية، وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية، وبين نصارى مصر، أو بين الملكانية والمنوفيسية بلفظ أصح.
وقد اشتد الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع حتى صار كأنه حرب بين دينين متنافسين، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى، كل طائفة تقول للأخرى: إنها ليست على شيء... وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه الجلود، فرجال كانوا يُعذّبون ثم يُقتلون إغراقاً، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض، ويُوضع السجين في كيس مملوء من الرمال ويُرمى به في البحر، إلى غير ذلك من الفظائع "(12).
وحدث بين اليهود والنصارى ما هو أشد هولاً، ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس (610م) على سبيل المثال، أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية، فأرسل الإمبراطور قائده أبنوسوس ليقضي على ثورتهم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة، فقتل الناس جميعاً، قتلاً بالسيف، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ورمياً للوحوش الكاسرة.
وحدث ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة , وهذه واحدة من نماذج التعامل بين الطرفين يوردها المؤرخ المصري المقريزي: " في أيام فوقا ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخرّبوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام، وقتلوا النصارى أجمعهم، وأتوا إلى مصر في طلبهم، وقتلوا منهم أمة كبيرة، وسبوا منهم سبياً لا يدخل تحت حصر، وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم، وأقبلوا نحو الفرس من كل مكان , فنالوا من النصارى كل منال، وأعظموا النكاية فيهم، وخرّبوا لهم كنيستين في القدس، وأحرقوا أماكنهم , وأسروا بطريك القدس وكثيراً من أصحابه...
وكان هرقل قد ملك الروم، وغلب الفرس، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر , ويجدد ما خربه الفرس، فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها وقدموا له الهدايا الجليلة، وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف لهم على ذلك، فأمّنهم وحلف لهم، ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأناجيل والصلبان، فوجد المدينة وكنائسها خراباً، فساءه ذلك، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس، وأنهم كانوا اشد نكاية لهم من الفرس، وحثوا هرقل على الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه، فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم وقسيسوهم بأنه لا جرم عليه في قتلهم، فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء , أبادهم جميعهم فيها، حتى لم يبق في ممالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فر واختفى"(13).
أما ما فعله النصارى بالمسلمين عندما تمكنوا منهم، فيكفي أن نشير إلى ما نفذته السلطة والكنيسة الاسبانيتين عن طريق محاكم التحقيق مع بقايا المسلمين في الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسية: غرناطة، مما قصه علينا بالتفصيل العلمي الموثق محمد عبد الله عنان في كتابه القيم (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين)(14)، وما فعلته قوى الاستعمار الصليبي في آسيا وإفريقية مع الشعوب الإسلامية عبر القرون الأخيرة، وما تفعله القيادات الإفريقية النصرانية مع المسلمين.
(4)
في العصر الأموي والعصور العباسية التالية، حين ازداد المجتمع الإسلامي تعقيداً واتساعاً، وأخذت منحنيات الإبداع الحضاري تزداد صعوداً واطراداً، وتزداد معها المؤسسات الإدارية نضجاً ونمواً، أخذ الموقف من غير المسلمين يتألق بالمزيد من صيغ التعامل الإنساني أخذاً وعطاء.
لقد فتح المسلمون ـ قواعد وسلطة ـ صدورهم لغير المسلمين يهوداً ونصارى ومجوساً وصابئة، وأتاحوا للعناصر المتميزة من هؤلاء وهؤلاء احتلال مواقعهم الاجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص، لم تعرفه أمة من الأمم عبر تاريخ البشرية كله.
لقد ساهم غير المسلمين في صنع الحضارة الإسلامية وإغنائها، دونما أي عقد أو حساسيات من هذا الجانب أو ذاك، كما فُتح الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب، بدءاً من الكتابة في الدواوين وانتهاء بمركز الوزارة الخطير نفسه، وأُتيح لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى أن يتحركوا في ساحات النشاط الاقتصادي والمالي بحرية تكاد تكون مطلقة، فنمّوا ثرواتهم وارتفعوا بمستوياتهم الاجتماعية بما يوازي قدراتهم على العمل والنشاط، وملؤوا بهذا وذاك مساحة واسعة في ميدان النشاط الاقتصادي والمالي جنباً إلى جنب مع مواطنيهم المسلمين، بل إن بعض الأنشطة المالية والاقتصادية كادت تصبح من اختصاص أهل الكتاب، تماماً كما كانت الترجمة في المجال الثقافي من نصيبهم، وكما كانت بعض الوظائف الإدارية والكتابية في المجال الإداري من نصيبهم كذلك.
إنه مجتمع تكافؤ الفرص والحرية العقديّة والانفتاح , لقد استجاب المسلمون للتحدي الاجتماعي، وكانوا في معظم الأحيان عند حسن ظن رسولهم - صلى الله عليه وسلم- بهم، وهو يوصيهم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أن يكونوا رفقاء بأهل الذمة!! .
الوقائع كثيرة، تيار من المعطيات التاريخية نفذت في ساحة المجتمع الإسلامي عبر القرون الطوال، نفذت على مختلف الجبهات ووفق سائر الاتجاهات الحضارية والإدارية والاقتصادية، والاجتماعية عموماً.. ونلتقي بشهادة فيليب حتي في كتابه (تاريخ العرب المطول) فهي تحمل دلالتها ولا ريب كشاهد على معطيات هذا التيار الواسع: " تمتع أهل الذمة بقسط من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج.
وارتبطت بالفعل قضاياهم في الأمور المدنية والجنائية برؤسائهم الروحيين، إلا إذا كانت القضية تمسّ المسلمين... ".
" لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية، كما كان شاعره نصرانياً، وكذلك كان طبيبه وأمير المال في دولته... "(15).
"وأقام الذميون في مزارعهم ومنازلهم الريفية، وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغاتهم الأصلية؛ فكانت لهم الآرامية والسريانية لغة في سوريا والعراق، والإيرانية في فارس، والقبطية في مصر... وفي المدن تقلد النصارى واليهود مناصب هامة في دوائر المال والكتابة والمهن الحرة، وتمتعوا في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية، ونالوا كثيراً من التساهل والعطف.
وشهد بلاط العباسيين مناقشات كتلك التي جرت في بلاط معاوية وعبد الملك، وقد ألقى تيموتاوس بطريك النساطرة في سنة (781 م) دفاعاً عن النصرانية أمام المهدي، لا يزال محفوظاً نصه إلى اليوم , كذلك تحدّرت إلينا رسالة للكندي تصرح أنها بيان لمناقشة جرت سنة (819 م) في حضرة المأمون في مقابلة بين محاسن الإسلام والنصرانية...".
وكان للعهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس ترجمات عربية معروفة، وهناك أخبار تذكر أن رجلاً يُدعى (أحمد بن عبد الله بن سلام) كان قد ترجم التوراة إلى العربية منذ ولاية هارون الرشيد. ولدينا ما يثبت أيضاً أقساماً من التوراة كانت قد نُقلت إلى العربية في القسم الأخير من القرن السابع.
" ثم إننا نعرف وزراء نصارى قاموا في الشطر الثاني من القرن التاسع منهم عبدون بن صاعد.. وكان للمتقي وزير نصراني، كما كان لأحد بني بويه وزير آخر.
أما المعتضد فقد جعل في المكتب الحربي لجيش المسلمين رئيساً نصرانياً, وقد نال أمثال هؤلاء النصارى من أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤهم المسلمون من الإكرام والتبجيل... وكانت أكثرية أطباء الخلفاء أنفسهم من أبناء الكنيسة النسطورية.
وقد نُشر أخيراً براءة منحها المكتفي سنة ( 1138 م ) لحماية النساطرة، وهي توضح مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين رجال النصرانية.
" ومن أعجب الظواهر في حياة النصرانية في ظل الخلفاء، أنه كان لها من القوة والنشاط ما دفع بها إلى التوسع فافتتحت لها مراكز تبشيرية في الهند والصين..". " ولقد لقي اليهود من محاسن المسلمين فوق ما لقيه النصارى بالرغم مما في بعض الآيات القرآنية من تنديد بهم.
والسبب أنهم كانوا قليلي العدد فلم يُخش أذاهم. وقد وجد المقدسي سنة (985م) أن أكثر الصيارفة وأرباب البنوك في سورية يهود، وأكثر الكتبة والأطباء نصارى.
ونرى في عهد عدد من الخلفاء وأخصهم المعتضد أنه كان لليهود في الدولة مراكز هامة. وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت فيها مزدهرة حتى سقوط المدينة. وقد زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حوالي سنة (1169م) ، فوجد فيها عشر مدارس للحاخامين، وثلاثة وعشرين كنيساً، وأفاض بنيامين في وصف الحفاوة التي لاقاها رئيس اليهود البابليين من المسلمين، بصفته سليل بيت داود النبي عليه السلام ورئيس الملة الإسرائيلية، وقد كان لرئيس الحاخامين هذا من السلطة التشريعية على أبناء طائفته ما كان للجاثليق على جميع النصارى.
وقد روى إنه كانت له ثروة ومكانة وأملاك طائلة فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة , وكان إذا خرج إلى المثول في حضرة الخليفة ارتدى الملابس الحريرية المطرزة، وأحاط به رهط من الفرسان، وجرى أمامه ساع يصيح بأعلى صوته: " أفسحوا درباً لسيدنا ابن داود .."(16).
وما يُقال عن العصرين الأموي والعباسي، يمكن أن يُقال عن العصور التي تلتهما: الفاطميون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون، لولا بعض ردود الأفعال الغاضبة التي اعتمد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة اتخذتها هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب، فمالأت خصوم المسلمين، ووضعت أيديها بأيدي الغزاة الذين قدموا لإبادتهم وإفنائهم، وتآمرت سراً وجهراً لتدمير عقيدتهم وإزالة ملكهم من الأرض.
ويمكن أن يذكر المرء ـ ها هنا ـ المواقف العدائية العديدة التي اتخذها نصارى الشام والجزيرة والموصل والعراق عامة، خلال محنة الغزو المغولي؛ إذ رحبت جماعات منهم بالغزاة، وتآمرت معهم ضد مواطنيهم المسلمين، فاحتضنهم الغزاة واستخدموهم في فرض هيمنتهم، واتخذوهم مخالب لتمزيق أجساد المسلمين الذين عاشوا معهم بحرية وإخاء عبر القرون الطوال، ويمكن أن نتذكر كذلك التجارب المرة نفسها التي مارستها جماعات من اليهود والنصارى في العصر العثماني، وردود الأفعال العثمانية إزاءها.. الخ.
لكن هذه الحالات لم تكن في نهاية التحليل، ومن خلال نظرة شمولية لحركة المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ، سوى استثناءات أو نقاط سوداء محدودة على صفحة واسعة تشع بياضاً، على العكس تماماً مما شهدته المجتمعات الأخرى؛ حيث كانت حالات الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الدين الحاكم ومخالفيه نقاطاً استثنائية بيضاء في صفحة تنفث حقداً ودخاناً.
ومن عجب أن مرحلة الحروب الصليبية نفسها، تلك التي دامت حوالي القرنين من الزمن، وكان الغزاة فيها يحملون الطائفية والكراهية ضد كل ما هو إسلامي، والتي جاءت لكي تدمر على المجتمع الإسلامي أمنه واستقراره، وتفتنه عن دينه لصالح الكنيسة المتعصبة، هذه التجربة المرة لم تسق القيادات والمجتمعات الإسلامية إلى ردود فعل طائفية تقودهم إلى عدم التفرقة، وهم يتحركون بسيوفهم، بين الغزاة وبين النصارى المحليين، رغم أن فئات من هؤلاء تعاونت علناً مع الغزاة , ووضعت أيديها في أيديهم، وتآمرت معهم على إنزال الدمار بالإسلام والمسلمين.
ولحسن الحظ فإن الغزاة الذين انطلقوا أساساً من نقطة التعصب والمذهبية، مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم في العقيدة ممن ينتمون لأجنحة نصرانية أخرى، بدءاً من البيزنطيين الأرثوذكس، وانتهاء بجل الفئات النصرانية المحلية، ممن لم تدن بالمذهب الكاثوليكي الذي انضوى تحت لوائه معظم الغزاة، ولولا ذلك لامتدت مساحة التعاون بين الطرفين، فيما كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر وخامة.
المهم إننا لم نشهد عبر مرحلة الحروب الصليبية هذه بثوراً طائفية، في نسيج المجتمع الإسلامي، كرد فعل لغزو وهو في أساسه ديني متعصب.. لم نسمع بمذبحة ارتكبها المسلمون ضد رفاقهم في الأرض، ولا بعمل انتقامي غير منضبط نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم!!
وما من شك في أن هذا الانفتاح الذي شهده المجتمع الإسلامي إزاء العناصر غير الإسلامية، والفرص المفتوحة التي منحها إياهم، قاد بعض الفئات ـ كما رأينا ـ إلى ما يمكن عدّه استغلالاً للموقف السمح، ومحاولة لطعن المسلمين في ظهورهم، وتنفيذ محاولات تخريبية على مستوى السلطة حيناً، والعقيدة حيناً، والمجتمع نفسه حيناً ثالثاً، وإننا لنتذكر هنا ـ على سبيل المثال كذلك ـ ما فعلته الطوائف اليهودية بدءاً من محاولات السبئية، وانتهاء بمؤامرة الدونمة لإسقاط الخلافة العثمانية، وما فعلته بعض الطوائف المجوسية في العصر العباسي فيما يشكل العمود الفقري للحركة الشعوبية، التي استهدفت العرب والمسلمين على السواء.
لكن هذه الخسائر التي لحقت بالمسلمين من جراء تعاملهم الإنساني مع مخالفيهم في العقيدة، والمخاطر التي تعرضوا لها عبر تاريخهم الطويل، من قبل هؤلاء الخصوم الذين استغلوا الفرصة، وسعوا إلى ممارسة التخريب والتآمر والالتفاف لا تسوّغ البتة اعتماد صيغ في التعامل غير تلك التي اعتمدها المسلمون في تاريخهم الاجتماعي الطويل .. وتقاليد غير تلك التي منحهم إياها، ورباهم عليها كتاب الله، وسنة رسوله عليه السلام، وتجارب الآباء والأجداد.
إن الخسائر الجزئية ـ مهما كانت فداحتها ـ لأهون بكثير من الخسارة الكبرى ذات البعد الإنساني، وإن الإسلام نفسه - قبل غيره من الأديان- كان سيخسر الكثير لو حاول أن يسعى إلى تحصين نفسه بالحقد والطائفية، والردود المتشنّجة التي تجاوز حدودها المعقولة والمسوّغة.
وإن الإنسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن المجتمع الإسلامي خرج على التقاليد النبيلة المتألقة التي علّمه إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه ـ فيما عدا التاريخ الإسلامي ـ فإنه ليس ثمة في تاريخ البشرية ـ قديماً وحديثاً ـ مرحلة كتاريخ الإسلام احترم فيها فكر المخالفين وصينت عقائدهم، وحُميت حقوقهم، بل كانوا ـ على العكس تماماً ـ هدفاً للاستعباد والهوان والضياع، بل التصفية والإفناء.
لم يكن هدف الفتوحات الإسلامية جميعها، منذ عصر الرسول القائد - صلى الله عليه وسلم- وحتى سقوط العثمانيين فرض العقيدة الإسلامية بالقوة كما يتعمد البعض أن يصور أو يتصور.
إنما نشر السيادة والمنهج الإسلامي في العالم , إنها محاولة جادة لتسلم القيادة من الأرباب والطواغيت، وتحويلها إلى أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً.
وتحت ظلال هذه القيادة، كان بمقدور الناس، وقد حُرّروا تماماً من أي ضغط أو تأثير مضاد أن ينتموا للعقيدة التي يشاؤون، ولما كانت عقيدة الإسلام هي الأرقى والأجدر والأكثر انسجاماً مع مطالب الإنسان بأي مقياس من المقاييس، كان من الطبيعي أن تنتشر بين الناس، وأن ينتمي إليها الأفراد والجماعات بالسرعة التي تبدو للوهلة الأولى أمراً محيراً، ولكن بالتوغل في الأمر يتبين مدى منطقية هذا الإقبال السريع الذي يختزل الحيثيات، انتماءً إلى الإسلام وتحققاً بعقيدته.. إنه الجذب الفعّال الذي تملكه هذه العقيدة، والاستجابة الحيوية لحاجات الإنسان في أشدها اعتدالاً وتوازناً وانسجاماً، تلك التي يحققها هذا الدين.
إن سير توماس أرنولد، وهو رجل من الغرب سبق وأن أشرنا إليه، يتفرغ السنين الطوال لمتابعة هذه المسألة، ثم يعلنها في كتابه المعروف (الدعوة إلى الإسلام) بوضوح لا لبس فيه، واستناد علمي على الحقائق وحدها بعيداً عن التأويلات والتحزّبات والميول والأهواء.
ونكتفي هنا ببعض الشهادات التي قدمها هذا الباحث كنماذج تؤكد البعد الإنساني للسلوكية التي اعتمدها الإسلام في الانتشار. يقول الرجل: "يمكننا أن نَحكُم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس إلى الإسلام , فمحمد نفسه عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية، وأخذ على عاتقه حمايتهم , ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة"(17).
"إن الأخبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية النصرانية التي كانت تعيش في بلاد العرب الشمالية، لا تزال بحاجة إلى شيء من التفصيل، والظاهر أنهم قد انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه الاندماج السلمي، والذي تم بطريقة لم يحسسها أحد منهم، ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم في الإسلام بالقوة عندما انضووا بادئ الأمر تحت الحكم الإسلامي، لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسيين"(18) .
"ومن هذه الأمثلة التي قدمناها عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة، واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح"(19) .
"لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون: "يا معشر العرب أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا , وأرأف بنا , وأكف عن ظلمنا , وأحسن ولاية علينا , ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا" ، وأغلق أهل حمص مدينتهم دون جيوش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم"(20) .
" أما ولايات الدولة البيزنطية التي سرعان ما استولى عليها المسلمون ببسالتهم، فقد وجدت أنها تتمتع بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة، بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية، فقد سُمح لهم أن يؤدّوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد، اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود التي فُرضت عليهم منعاً لإثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة.
ويمكن الحكم على مدى هذا التسامح ـ الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع ـ من هذه العهود التي أعطاها العرب لأهالي المدن التي استولوا عليها، وتعهدوا لهم بحماية أرواحهم وممتلكاتهم , وإطلاق الحرية الدينية لهم في مقابل الإذعان ودفع الجزية(21) " وقد زار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق، وقيل: إنه بينما كانا في كنيسة القيامة- وقد حان وقت الصلاة- طلب البطريق إلى عمر أن يصلي هناك، ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول: إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيما بعد أنه محل لعبادة المسلمين"(22) " وكان المسيحيون يؤدون الجزية مع سائر أهل الذمة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين"(23) .
" ولما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعاتهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم، ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني، تمتعوا- وخاصة في المدن- بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة"(24) ، " زار راهب دومنيكاني من فلورنسا ويدعى (Ricoldos de Monre Crucis) بلاد الشرق حوالي نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، وتحدث عن روح التسامح التي تمتع بها النساطرة إلى عصره في ظل الحكم الإسلامي فقال: "قرأت في التاريخ القديم وفي مؤلفات للعرب موثوق بها أن النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء لمحمد وحلفاء له، وأن محمداً نفسه قد أوصى خلفاءه أن يحرصوا على صداقتهم مع النساطرة، التي يرعاها العرب أنفسهم حتى ذلك اليوم بشيء من العناية"(25) .
وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي، ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق"(26) ، "إننا لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قُصد منه استئصال الدين المسيحي.
ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهباً يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة.
وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تاماً عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم بصفتهم طوائف خارجة عن الدين, ولهذا فإن مجرد بقاء الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم"(27) ، " جلب الفتح الإسلامي إلى الأقباط في مصر حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان.
وقد تركهم عمرو أحراراً على أن يدفعوا الجزية، وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم بذلك؛ من التدخل المستمر الذي عانوا من عبثه الثقيل في ظل الحكم الروماني.. وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتداد الأقباط عن دينهم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكامهم الحديثين, بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح، حين كانت الإسكندرية حاضرة مصر وقتئذ لا تزال تقاوم الفاتحين، وسار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة"(28).
هذه لمحات عن منطقة محدودة فحسب هي العراق والشام، ومصر إلى حد ما، من العالم الذي امتد إليه الإسلام وتعامل معه، فهنالك بلاد فارس وأواسط آسيا، وإفريقية، وأسبانيا، وجنوبي أوروبا وشرقيها، والهند والصين، وجنوب آسيا، مما تحدث عنه أرنولد فأطال الحديث.
--------------------------------------------------------------------------------
الهوامش
(1) أنظر: عماد الدين خليل: دراسة في السيرة، ط15، دار النفائس، بيروت ـ 1997م، الفصلان الثامن والتاسع.
(2) محمد بن سعد ( ت 230 هـ ) كتاب الطبقات الكبرى، تحقيق ادوارد سخاو ورفاقه، مصور عن طبعة ليدن، بريل ـ 1325 هـ ( بدون تاريخ ) 1/2/36، 84 ـ 85، أحمد بن يحيى البلاذري ( ت 279 هـ )، فتوح البلدان، تحقيق صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة، القاهرة 1957 م، 1/76 ـ 78، أحمد بن واضح اليعقوبي ( ت 282 هـ )، تاريخ اليعقوبي، تحقيق محمد صالح بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف ـ 1964 م، 2 / 71 ـ 72.
(3) البلاذري: فتوح البلدان 1 / 78.
(4) ابن سعد: الطبقات 1/2/28 ـ 30.
(5) المصدر نفسه 1 / 2 / 38.
(6) عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص 358.
(7) الدعوة إلى الإسلام، ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن ورفاقه، ط3 مكتبة النهضة، القاهرة ـ 1971، ص 79.
( المرجع نفسه : ص 86 ـ 88 .
المرجع نفسه : ص 86 ـ 88 .
(9) المرجع نفسه : ص 130.
(10) ينظر المرجع نفسه للإطلاع على المزيد من الشواهد.
(11) حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ط3، دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة ـ 1956 م، ص 336.
(12) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط5، مكتبة دار العروبة، القاهرة ـ 1964 م، ص 29 ـ 30.
(13) المرجع نفسه، ص 36 ـ 37.
(14) وهو الكتاب الرابع من دولة الإسلام في الأندلس، ط2، مطبعة مصر، القاهرة ـ 1958 م.
(15) تاريخ العرب المطول، ط4 ، دار الكشاف ، بيروت ـ 1965 م، 1/ 301 ـ 302.
(16) المرجع نفسه 2 / 432 ـ 438 وينظر : ول ديورنت : قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران وآخرين، ط2 ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ـ 1964 ـ 1967 م، 13 / 131، وآرثر ستانلي تريتون : أهل الذمة في الإسلام ، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ط2، دار المعارف، القاهرة ـ 1967 م، ص 170.
(17) الدعوة إلى الإسلام، ص 65.
(18) المرجع نفسه، ص 68.(19) المرجع نفسه، ص 69 ـ 70.
(20) المرجع نفسه، ص 73.
(21) المرجع نفسه، ص 74.
(22) المرجع نفسه، ص 75.
(23) المرجع نفسه، ص 79.
(24) المرجع نفسه، ص 81.
(25) المرجع نفسه، هامش 1 ، ص 81.
(26) المرجع نفسه، ص 88.
(27) المرجع نفسه، ص 98 ـ 99.
(28) المرجع نفسه، ص 123 ـ 124.
ليس من مهمة هذا البحث متابعة المعطيات الفقهية الخصبة والمتميزة بصدد التعامل مع الآخر، وإنما التأشير على بعض الممارسات التاريخية كشواهد فحسب، من بين سيل من الوقائع لا يكاد يحصيها عدّ، تؤكد فيما لا يدع أي مجال للشك في أن النصارى واليهود من أهل الكتاب، وغيرهما من الفرق الدينية الأخرى، عاشوا حياتهم، ومارسوا حقوقهم الدينية والمدنية على مداها في ديار الإسلام، فيما لم تشهده ولن تشهده أية تجربة تاريخية في العالم.
إن التاريخ هو الحكم الفصل في قدرة المذاهب والأديان على التماسّ مع الواقع، وتحويل "الكلمة" إلى فعل منظور.
ابتداءً.. ما الذي أرادت التأسيسات القرآنية أن تقوله فانعكس ـ بالتالي ـ في نسيج الفعل التاريخي بين المسلم وغير المسلم؟
إن التغاير والاختلاف قائمان في صميم العلاقات البشرية، والتوحّد في وجوهه كافة لا ينفي التغاير، كما أن هذا لا ينفي التوحّد، إنهما يتداخلان ويتوازيان ويؤثر أحدهما في الآخر، بل قد يرفده بعناصر القوة والخصب والنماء.
قد تحدث حالات تقاطع تقود أحياناً إلى النفي والتعارض، لكن الخط الأكثر عمقاً وامتداداً هو أن التجربة البشرية من لحظات تشكلها الأولى وحتى يقوم الحساب، إنما هي تجربة تتعدد فيها الانتماءات وتتغير العلاقات وتتنوع القناعات، وأن هذا التغاير في حدوده المعقولة، ومن خلال تعامله مع الثوابت التوحيدية، هو الذي يمنح التاريخ البشري، ليس فقط تفرده وخصوصيته، وإنما قدرته على الفعل والصيرورة.
في المنظور القرآني يبدو التنوع مستقطباً عبر مجراه الطويل بكلمتي الإيمان والكفر، أو الحق والباطل، ترفده جداول وأنهار متشابكة تجيء من هذا الصوب أو ذاك، ومن خلال هذا التغاير تتحرك مياه التاريخ فلا تركد ولا تأسن، وتحفظ بهذا قدرتها على التدفق والنقاء.
إن الإرادة الحرة والاختيار المفتوح اللذين مُنحا للإنسان فرداً وجماعة، للانتماء إلى هذا المذهب أو ذاك، يقودان بالضرورة إلى عدم توحد البشرية وتحوّلها إلى معسكر واحد.. إن قيمة الحياة الدنيا وصيرورتها المبدعة تكمن في هذا التغاير، وإن حكمة الله سبحانه شاءت ـ حتى بالنسبة للكتلة أو المعسكر الواحد ـ أن تشهد انقساماً وتغايراً وتنوّعاً وصراعاً.
والقرآن الكريم يحدثنا عن هذا التغاير في أكثر من صورة ووفق أشد الصيغ واقعية ووضوحاً: " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات" [المائدة : 48] ، " ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم " [هود: 118ـ 119] ، " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ..."[البقرة: من الآية 253]، "...ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد" [البقرة:من الآية 253].
بل إن القرآن انطلاقاً من منظوره الواقعي لحركة التاريخ البشري يبين في أكثر من موضع أن (الأكثريات) البشرية تقف دائماً بمواجهة الحق الذي لا تنتمي إليه إلاّ القلة الطليعية الرائدة، نظراً لما يتطلبه هذا الانتماء من جهد وتضحية وعطاء لا يحتملها الكثيرون: "بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون" [المؤمنون: 70].
وكثيراً ما يكون اختلاف الألسنة والألوان، الذي يعقبه تغاير الثقافات وتعدد الأعراق، أحد العوامل الأساسية التي تكمن وراء التنوع التاريخي الذي هو بحد ذاته صيغة من صيغ الإبداع الإلهي في العالم: " ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم إذا أنتم بشر تنتشرون" [الروم:20].
"ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" [الروم : 22].
أما عن الهدف من وراء هذا التغاير فإن القرآن يجيب: (...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين" [البقرة: 251] " ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز" [الحج: 40].
تلك هي الأمور الأساسية، إن هذا التغاير والتدافع المركوز في جبلة بني آدم يقود إلى (تحريك) الحياة نحو الأحسن، وتخطي مواقع السكون والفساد، ومنح القدرة للقوى الإنسانية الراشدة كي تشد عزائمها قبالة التحديات، وأن تسعى لتحقيق المجتمع المؤمن الذي ينفذ أمر الله وكلمته في العالم.
وثمة آيات أخرى تبين كيف أن هذا التغاير الذي يعقب تدافعاً وصراعاً إنما هو ميدان حيوي للكشف عن مواقف الجماعة البشرية، والتعرف على أصالة المؤمنين , ففي جحيم القتال، وعلى وهجه المضيء يتضح الذهب من التراب، ويتميز الطيب من الخبيث، وتتحول التجربة إلى منخال كبير يسقط، وهو يتحرك يميناً وشمالاً، كل الضعفة والمنافقين والعاجزين والمتردّدين في مواصلة الحركة صوب المصير المرسوم: " ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم " [محمد: 31] ، "ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون". [الأنفال: 37].
وما أكثر ما يتساءل الإنسان عن الحكمة من التقاتل، وما أكثر ما تخيل الفلاسفة والمفكرون عالماً لا يشهد قتالاً ولا تُسفك في ساحته الدماء، ولكن هيهات ما دامت المسألة مرتبطة في جذورها بالوجود البشري المتغاير المتنوع. ولا يزال الصراع أمراً لا مفر منه إذا ما أريد للحياة الإنسانية أن تتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون والفساد: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون" [البقرة: 216].
إلا أن القرآن ـ وهو يتحدث عن الصراع الناجم عن التغاير البشري في المذاهب والأجناس واللغات والمصالح والبيئات الجغرافية ـ لا يقصر المسألة على التقاتل والتدافع، إنما يمدها إلى ساحة أوسع، ويعطي للتغاير البشري آفاقاً بعيدة المدى، تبدأ بإشهار السلاح، وتمتد لكي تصل إلى الموقف الأكثر إيجابية، والذي يجعل هذا التغاير سبباً لعلاقات إنسانية متبادلة بين الأمم والأقوام والشعوب للتقارب والتعاون والتعارف، مع بقاء كل منها على مذهبه أو جنسه أو لونه أو لغته أو بيئته الجغرافية: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله اتقاكم، إن الله عليم خبير" [الحجرات: 13].
(2)
وجاء تاريخنا الإسلامي لكي يمنح مساحة واسعة للتغاير، وقبول الآخر، والتحاور معه.. والوقائع في هذا السياق كثيفة جداً ،ولذا سنكتفي بالتأشير على بعضها.
فمنذ بدايات مبكرة قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة، يهوداً ونصارى، موقفاً منفتحاً رسمت من خلاله تقاليد العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، ووُضعت أصولها ونُظّمت صيغها، وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية مضت معها هذه التقاليد والأصول والصيغ تعمل في مجرى العلاقات الاجتماعية، وما حدث بين الحين والحين من خروج عليها , فإنه لم يتجاوز أن يكون شذوذاً على القاعدة ازدادت تأكيداً بمرور الأيام.
ما الذي أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقوله وينفذه إزاء غير المسلمين من أهل الكتاب؟ إن بمقدور القارئ أن يرجع إلى كتب السيرة للعثور على الجواب الشامل بجزئياته وتفاصيله(1)، ولكننا نود أن نشير مجرد إشارة إلى العهد الذي كتبه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أعقاب غزوة تبوك عام 9 هـ لنصارى نجران، ذلك العهد الذي يمثل قمة من قمم العدل والسماحة والحرية، والذي لم يفرض عليهم فيه سوى جزية عينية متواضعة، وقد جاء فيه: " ولنجران وحاشيتهم جوار الله ... ومن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين... ولا يُؤاخذ أحد منهم بظلم آخر. وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة النبي - صلى الله عليه وسلم- أبداً، حتى يأتي الله بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما عليهم"(2)، وقد دخل يهود نجران في هذا الصلح(3).
كما نود أن نشير إلى العهود التي كتبها لعدد من التجمعات اليهودية في شمال الجزيرة ، بعد غزوة خيبر ( 7 هـ ) والسنين التي تلتها؛ إذ بعث إلى بني جنبة بمقنة القريبة من أيلة على خليج العقبة: "أما بعد، فقد نزل علي رسلكم راجعين إلى قريتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله، وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم، لا ظلم عليكم ولا عدى، وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه.. وإن عليكم ريع ما أخرجت نخلكم وصادت عروككم (مراكبكم) واغتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة، فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم، وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله...". وكتب لجماعة أخرى من اليهود تدعى (بني غاديا): "... إن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء"، كما كتب لبني عريض كتاباً آخر يحدد فيه ما عليهم أن يدفعوا للمسلمين لقاء حمايتهم لهم وعدم ظلمهم إياهم(4).
وكتب لأهل جرباء وأذرح من اليهود: "إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليهم مائة دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان للمسلمين، ومن لجأ إليه من المسلمين"(5).
وبذلك تمكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من تحويل هذه التجمعات اليهودية إلى جماعات من المواطنين في الدولة الإسلامية يدفعون لها ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو عينية، ويحتمون بقوتها وسلطانها، ويتمتعون بعدلها وسماحتها.
ولقد ظل اليهود ـ والنصارى بطبيعة الحال ـ كمواطنين وليسوا كتلاً سياسية أو عسكرية ـ يمارسون حقوقهم في إطار الدولة الإسلامية لا يمسسهم أحد بسوء، وعاد بعضهم إلى المدينة، بدليل ما ورد عن عدد منهم في سيرة ابن هشام , وفي مغازي الواقدي.
وهناك الكثير من الروايات والنصوص التاريخية التي تدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان يعامل اليهود بعد غزوة خيبر بروح التسامح، حتى إنه أوصى عامله معاذ بن جبل: "بأن لا يفتن اليهود عن يهوديتهم"، وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين؛ إذ لم يُكلّفوا إلا بدفع الجزية، وبقوا متمسكين بدين آبائهم(6).
وجاء الراشدون لكي يشهد المجتمع الإسلامي تنفيذاً في العلاقات الإنسانية بين المسلمين وغيرهم لا يقل تفرداً وتألقاً عما شهده عصر الرسالة , فلقد كان العصر الجديد عصر الفتوح والامتداد الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت مساحات واسعة من الأراضي التي بلغها الإسلام تضم حشوداً كبيرة من اليهود والنصارى والمجوس والطوائف الدينية الأخرى.
لقد أصبح المجتمع الإسلامي بحركة الفتح هذه مجتمعاً عالمياً ضم جناحيه على أعداد كبيرة من الأجناس والأديان والأقوام والجماعات والمذاهب والفرق والاتجاهات، ونريد أن نعرف كيف تم التعامل معها عبر عمليات الفتح أولاً، وبعد استقرار الوجود الإسلامي ثانياً، وهل تمكن المسلمون من الاستجابة لتحديات التنوع المذهبي في جتمعهم العالمي الجديد؟
يقول السير (توماس أرنولد) الذي سنعتمد على عدد من شهاداته بهذا الصدد في كتابه المعروف: (الدعوة إلى الإسلام The Preaching to Islam) الذي يتضمن تحليلاً مدعماً بالوثائق والنصوص للصيغ الإنسانية التي اتبعها الإسلام في تعامله مع أبناء المذاهب الأخرى.
" ... لما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة "أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم"، وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: "فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا".
ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط من تلك الحادثة التي وقعت في حكم الخليفة عمر: لما حشد الإمبراطور هرقل جيشاً ضخماً لصد قوات المسلمين كان لزاماً على المسلمين-نتيجة لما حدث- أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم , فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم أن يردوا عليه ما جُبي من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: " إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله عليهم"، وبذلك رُدّت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: "ردكم الله علينا ونصركم عليهم ـ أي على الروم ـ فلو كانوا هم لم يردوا شيئاً وأخذوا كل شيء بقي لنا"(7).
" يكشف تاريخ النساطرة عن نهضة رائعة في الحياة الدينية , وعن نواحي نشاطهم منذ أن صاروا رعية للمسلمين. وكان أكاسرة الفرس يدللون هذه الطائفة تارة ويضطهدونها تارة أخرى؛ إذ كان السواد الأعظم من أفرادها يقيمون في ولايات هؤلاء الأكاسرة، بل مرّوا بحياة أشد من هذه خطورة، وخضعوا لمعاملة خشنة قاسية حين جعلتهم الحرب بين فارس وبيزنطة عرضة لشك الفرس فيهم، بأنهم كانوا يمالئون أعداءهم من المسيحيين.
ولكن الأمن الذي نعموا به في بلادهم في عهد الخلفاء قد مكنهم من أن يسيروا قدماً في سبيل أعمالهم التبشيرية في الخارج، فأرسلوا البعوث الدينية إلى الصين والهند، وارتقى كل منهم إلى مرتبة المطرانية في القرن الثامن الميلادي.
وفي العصر نفسه تقريباً رسخت أقدامهم في مصر، ثم أشاعوا فيما بعد العقيدة المسيحية في آسيا، حتى إذا جاء القرن الحادي عشر كانوا قد جذبوا عدداً كبيراً ممن اعتنقوا المسيحية من بين التتار.
وإذا كانت الطوائف المسيحية الأخرى قد أخفقت في إظهار مثل هذا النشاط القوي، فليس هذا الإخفاق خطأ المسلمين؛ إذ كانت الحكومة المركزية العليا تتسامح مع جميعهم على السواء، وكانت فضلاً عن ذلك تصدهم عن أن يضطهد بعضهم بعضاً.
وفي القرن الخامس الميلادي كان (برصوما)، وهو أسقف نسطوري، قد أغرى ملك الفرس بأن يدبر اضطهاداً عنيفاً للكنيسة الأرثوذكسية، وذلك بإظهار نسطور بمظهر الصديق للفرس، وإظهار مبادئه بأنها أكثر ميلاً إلى مبادئهم.
" ويُقال: إن عدداً يبلغ (7800) من رجال الكنيسة الأرثوذكسية مع عدد ضخم من العلمانيين، قد ذُبحوا في هذا الاضطهاد. وقام خسرو الثاني باضطهاد آخر للأرثوذكس بعد أن غزا هرقل بلاد فارس، وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع الملك بأن الأرثوذكس سوف يظهرون بمظهر العطف والميل إلى البيزنطيين.
ولكن مبادئ المسلمين على خلاف غيرهم؛ إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهداً في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس.
مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس كنائسهم، ولكن المسلمين أعادوها أخيراً إلى أصحابها الشرعيين بعد أن دلل الأرثوذكس على ملكيتهم لها" (
"ومما يدل على أن تحوّل المسيحيين إلى الإسلام ـ في مصر ـ لم يكن راجعاً إلى الاضطهاد، ما وقفنا عليه من الشواهد التاريخية الأصلية، وهو أنه في الوقت الذي شغر فيه كرسي البطريركية تمتع المسيحيون بالحرية التامة في إقامة شعائرهم، وسُمح لهم بإعادة بناء كنائسهم، بل ببناء كنائس جديدة، وتخلّصوا من القيود التي حتمت عليهم أن يركبوا الحمير والبغال، وحوكموا في محاكمهم الخاصة، على حين أُعفي الرهبان من دفع الجزية , ومُنحوا امتيازات معينة"(9).
(3)
وما هي إلا لمحات فحسب مما تحدّث عنه توماس أرنولد فأطال الحديث، ولن تغني الشواهد هنا عن متابعة هذا الكتاب ـ الوثيقة ـ الذي يجيء على يد باحث يحترم العلم بالقدر الذي لم نألفه لدى الغربيين في تعاملهم مع عقيدتنا وتاريخنا إلا نادراً(10).
ما الذي كان يحدث في المجتمعات الأخرى بين أبناء الدين الغالب وبين المنتمين للأديان والمذاهب الأقل انتشاراً؟يقول غوستاف لوبون: "لقد أُكرهت مصر على انتحال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط الذي لم ينتشلها منه سوى الفتح العربي.
وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر التي كانت مسرحاً للاختلافات الدينية الكثيرة في ذلك الزمن , وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات، وكانت مصر، التي أكلتها الانقسامات الدينية وأنهكها استبداد الحكام، تحقد على سادتها الروم، وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قياصرة القسطنطينية الظالمين"(11).
ويقول الندوي: "ثارت حول الديانة النصرانية , وفي صميمها مجادلات كلامية شغلت فكر الأمة واستهلكت ذكاءها , وتحولت في كثير من الأحيان إلى حروب دامية، وقتل وتدمير وتعذيب ، وإغارة وانتهاب واغتيال، وحوّلت المدارس والكنائس والبيوت إلى معسكرات دينية تتنافس، وأقحمت البلاد في حرب أهلية، وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الديني ما كان بين نصارى الشام والدولة الرومية، وبين نصارى مصر، أو بين الملكانية والمنوفيسية بلفظ أصح.
وقد اشتد الخلاف بين الحزبين في القرنين السادس والسابع حتى صار كأنه حرب بين دينين متنافسين، أو كأنه خلاف بين اليهود والنصارى، كل طائفة تقول للأخرى: إنها ليست على شيء... وشهدت مصر من الفظائع ما تقشعر منه الجلود، فرجال كانوا يُعذّبون ثم يُقتلون إغراقاً، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض، ويُوضع السجين في كيس مملوء من الرمال ويُرمى به في البحر، إلى غير ذلك من الفظائع "(12).
وحدث بين اليهود والنصارى ما هو أشد هولاً، ففي السنة الأخيرة من حكم فوكاس (610م) على سبيل المثال، أوقع اليهود بالمسيحيين في أنطاكية، فأرسل الإمبراطور قائده أبنوسوس ليقضي على ثورتهم، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة، فقتل الناس جميعاً، قتلاً بالسيف، وشنقاً وإغراقاً وتعذيباً ورمياً للوحوش الكاسرة.
وحدث ذلك بين اليهود والنصارى مرة بعد مرة , وهذه واحدة من نماذج التعامل بين الطرفين يوردها المؤرخ المصري المقريزي: " في أيام فوقا ملك الروم بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد الشام ومصر فخرّبوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام، وقتلوا النصارى أجمعهم، وأتوا إلى مصر في طلبهم، وقتلوا منهم أمة كبيرة، وسبوا منهم سبياً لا يدخل تحت حصر، وساعدهم اليهود في محاربة النصارى وتخريب كنائسهم، وأقبلوا نحو الفرس من كل مكان , فنالوا من النصارى كل منال، وأعظموا النكاية فيهم، وخرّبوا لهم كنيستين في القدس، وأحرقوا أماكنهم , وأسروا بطريك القدس وكثيراً من أصحابه...
وكان هرقل قد ملك الروم، وغلب الفرس، ثم سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر , ويجدد ما خربه الفرس، فخرج إليه اليهود من طبرية وغيرها وقدموا له الهدايا الجليلة، وطلبوا منه أن يؤمنهم ويحلف لهم على ذلك، فأمّنهم وحلف لهم، ثم دخل القدس وقد تلقاه النصارى بالأناجيل والصلبان، فوجد المدينة وكنائسها خراباً، فساءه ذلك، وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس، وأنهم كانوا اشد نكاية لهم من الفرس، وحثوا هرقل على الوقيعة بهم وحسنوا له ذلك، فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه، فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم وقسيسوهم بأنه لا جرم عليه في قتلهم، فمال إلى قولهم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء , أبادهم جميعهم فيها، حتى لم يبق في ممالك الروم بمصر والشام منهم إلا من فر واختفى"(13).
أما ما فعله النصارى بالمسلمين عندما تمكنوا منهم، فيكفي أن نشير إلى ما نفذته السلطة والكنيسة الاسبانيتين عن طريق محاكم التحقيق مع بقايا المسلمين في الأندلس بعد سقوط آخر معاقلهم السياسية: غرناطة، مما قصه علينا بالتفصيل العلمي الموثق محمد عبد الله عنان في كتابه القيم (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين)(14)، وما فعلته قوى الاستعمار الصليبي في آسيا وإفريقية مع الشعوب الإسلامية عبر القرون الأخيرة، وما تفعله القيادات الإفريقية النصرانية مع المسلمين.
(4)
في العصر الأموي والعصور العباسية التالية، حين ازداد المجتمع الإسلامي تعقيداً واتساعاً، وأخذت منحنيات الإبداع الحضاري تزداد صعوداً واطراداً، وتزداد معها المؤسسات الإدارية نضجاً ونمواً، أخذ الموقف من غير المسلمين يتألق بالمزيد من صيغ التعامل الإنساني أخذاً وعطاء.
لقد فتح المسلمون ـ قواعد وسلطة ـ صدورهم لغير المسلمين يهوداً ونصارى ومجوساً وصابئة، وأتاحوا للعناصر المتميزة من هؤلاء وهؤلاء احتلال مواقعهم الاجتماعية والوظيفية في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص، لم تعرفه أمة من الأمم عبر تاريخ البشرية كله.
لقد ساهم غير المسلمين في صنع الحضارة الإسلامية وإغنائها، دونما أي عقد أو حساسيات من هذا الجانب أو ذاك، كما فُتح الطريق أمامهم للوصول إلى أعلى المناصب، بدءاً من الكتابة في الدواوين وانتهاء بمركز الوزارة الخطير نفسه، وأُتيح لأبناء الأديان والمذاهب الأخرى أن يتحركوا في ساحات النشاط الاقتصادي والمالي بحرية تكاد تكون مطلقة، فنمّوا ثرواتهم وارتفعوا بمستوياتهم الاجتماعية بما يوازي قدراتهم على العمل والنشاط، وملؤوا بهذا وذاك مساحة واسعة في ميدان النشاط الاقتصادي والمالي جنباً إلى جنب مع مواطنيهم المسلمين، بل إن بعض الأنشطة المالية والاقتصادية كادت تصبح من اختصاص أهل الكتاب، تماماً كما كانت الترجمة في المجال الثقافي من نصيبهم، وكما كانت بعض الوظائف الإدارية والكتابية في المجال الإداري من نصيبهم كذلك.
إنه مجتمع تكافؤ الفرص والحرية العقديّة والانفتاح , لقد استجاب المسلمون للتحدي الاجتماعي، وكانوا في معظم الأحيان عند حسن ظن رسولهم - صلى الله عليه وسلم- بهم، وهو يوصيهم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى أن يكونوا رفقاء بأهل الذمة!! .
الوقائع كثيرة، تيار من المعطيات التاريخية نفذت في ساحة المجتمع الإسلامي عبر القرون الطوال، نفذت على مختلف الجبهات ووفق سائر الاتجاهات الحضارية والإدارية والاقتصادية، والاجتماعية عموماً.. ونلتقي بشهادة فيليب حتي في كتابه (تاريخ العرب المطول) فهي تحمل دلالتها ولا ريب كشاهد على معطيات هذا التيار الواسع: " تمتع أهل الذمة بقسط من الحرية لقاء تأديتهم الجزية والخراج.
وارتبطت بالفعل قضاياهم في الأمور المدنية والجنائية برؤسائهم الروحيين، إلا إذا كانت القضية تمسّ المسلمين... ".
" لقد كانت ميسون زوجة معاوية نصرانية، كما كان شاعره نصرانياً، وكذلك كان طبيبه وأمير المال في دولته... "(15).
"وأقام الذميون في مزارعهم ومنازلهم الريفية، وتمسكوا بتقاليدهم الثقافية، وحافظوا على لغاتهم الأصلية؛ فكانت لهم الآرامية والسريانية لغة في سوريا والعراق، والإيرانية في فارس، والقبطية في مصر... وفي المدن تقلد النصارى واليهود مناصب هامة في دوائر المال والكتابة والمهن الحرة، وتمتعوا في ظل الخلافة بقسط وافر من الحرية، ونالوا كثيراً من التساهل والعطف.
وشهد بلاط العباسيين مناقشات كتلك التي جرت في بلاط معاوية وعبد الملك، وقد ألقى تيموتاوس بطريك النساطرة في سنة (781 م) دفاعاً عن النصرانية أمام المهدي، لا يزال محفوظاً نصه إلى اليوم , كذلك تحدّرت إلينا رسالة للكندي تصرح أنها بيان لمناقشة جرت سنة (819 م) في حضرة المأمون في مقابلة بين محاسن الإسلام والنصرانية...".
وكان للعهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس ترجمات عربية معروفة، وهناك أخبار تذكر أن رجلاً يُدعى (أحمد بن عبد الله بن سلام) كان قد ترجم التوراة إلى العربية منذ ولاية هارون الرشيد. ولدينا ما يثبت أيضاً أقساماً من التوراة كانت قد نُقلت إلى العربية في القسم الأخير من القرن السابع.
" ثم إننا نعرف وزراء نصارى قاموا في الشطر الثاني من القرن التاسع منهم عبدون بن صاعد.. وكان للمتقي وزير نصراني، كما كان لأحد بني بويه وزير آخر.
أما المعتضد فقد جعل في المكتب الحربي لجيش المسلمين رئيساً نصرانياً, وقد نال أمثال هؤلاء النصارى من أصحاب المناصب العالية ما ناله زملاؤهم المسلمون من الإكرام والتبجيل... وكانت أكثرية أطباء الخلفاء أنفسهم من أبناء الكنيسة النسطورية.
وقد نُشر أخيراً براءة منحها المكتفي سنة ( 1138 م ) لحماية النساطرة، وهي توضح مدى العلاقات الودية بين رجال الإسلام الرسميين وبين رجال النصرانية.
" ومن أعجب الظواهر في حياة النصرانية في ظل الخلفاء، أنه كان لها من القوة والنشاط ما دفع بها إلى التوسع فافتتحت لها مراكز تبشيرية في الهند والصين..". " ولقد لقي اليهود من محاسن المسلمين فوق ما لقيه النصارى بالرغم مما في بعض الآيات القرآنية من تنديد بهم.
والسبب أنهم كانوا قليلي العدد فلم يُخش أذاهم. وقد وجد المقدسي سنة (985م) أن أكثر الصيارفة وأرباب البنوك في سورية يهود، وأكثر الكتبة والأطباء نصارى.
ونرى في عهد عدد من الخلفاء وأخصهم المعتضد أنه كان لليهود في الدولة مراكز هامة. وكان لهم في بغداد مستعمرة كبيرة ظلت فيها مزدهرة حتى سقوط المدينة. وقد زار هذه المستعمرة بنيامين التطيلي حوالي سنة (1169م) ، فوجد فيها عشر مدارس للحاخامين، وثلاثة وعشرين كنيساً، وأفاض بنيامين في وصف الحفاوة التي لاقاها رئيس اليهود البابليين من المسلمين، بصفته سليل بيت داود النبي عليه السلام ورئيس الملة الإسرائيلية، وقد كان لرئيس الحاخامين هذا من السلطة التشريعية على أبناء طائفته ما كان للجاثليق على جميع النصارى.
وقد روى إنه كانت له ثروة ومكانة وأملاك طائلة فيها الحدائق والبيوت والمزارع الخصبة , وكان إذا خرج إلى المثول في حضرة الخليفة ارتدى الملابس الحريرية المطرزة، وأحاط به رهط من الفرسان، وجرى أمامه ساع يصيح بأعلى صوته: " أفسحوا درباً لسيدنا ابن داود .."(16).
وما يُقال عن العصرين الأموي والعباسي، يمكن أن يُقال عن العصور التي تلتهما: الفاطميون والأيوبيون والمماليك والعثمانيون، لولا بعض ردود الأفعال الغاضبة التي اعتمد فيها العنف لأول مرة بسبب من مواقف عدائية معلنة اتخذتها هذه الفئة أو تلك من أهل الكتاب، فمالأت خصوم المسلمين، ووضعت أيديها بأيدي الغزاة الذين قدموا لإبادتهم وإفنائهم، وتآمرت سراً وجهراً لتدمير عقيدتهم وإزالة ملكهم من الأرض.
ويمكن أن يذكر المرء ـ ها هنا ـ المواقف العدائية العديدة التي اتخذها نصارى الشام والجزيرة والموصل والعراق عامة، خلال محنة الغزو المغولي؛ إذ رحبت جماعات منهم بالغزاة، وتآمرت معهم ضد مواطنيهم المسلمين، فاحتضنهم الغزاة واستخدموهم في فرض هيمنتهم، واتخذوهم مخالب لتمزيق أجساد المسلمين الذين عاشوا معهم بحرية وإخاء عبر القرون الطوال، ويمكن أن نتذكر كذلك التجارب المرة نفسها التي مارستها جماعات من اليهود والنصارى في العصر العثماني، وردود الأفعال العثمانية إزاءها.. الخ.
لكن هذه الحالات لم تكن في نهاية التحليل، ومن خلال نظرة شمولية لحركة المجتمعات الإسلامية عبر التاريخ، سوى استثناءات أو نقاط سوداء محدودة على صفحة واسعة تشع بياضاً، على العكس تماماً مما شهدته المجتمعات الأخرى؛ حيث كانت حالات الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص بين أصحاب الدين الحاكم ومخالفيه نقاطاً استثنائية بيضاء في صفحة تنفث حقداً ودخاناً.
ومن عجب أن مرحلة الحروب الصليبية نفسها، تلك التي دامت حوالي القرنين من الزمن، وكان الغزاة فيها يحملون الطائفية والكراهية ضد كل ما هو إسلامي، والتي جاءت لكي تدمر على المجتمع الإسلامي أمنه واستقراره، وتفتنه عن دينه لصالح الكنيسة المتعصبة، هذه التجربة المرة لم تسق القيادات والمجتمعات الإسلامية إلى ردود فعل طائفية تقودهم إلى عدم التفرقة، وهم يتحركون بسيوفهم، بين الغزاة وبين النصارى المحليين، رغم أن فئات من هؤلاء تعاونت علناً مع الغزاة , ووضعت أيديها في أيديهم، وتآمرت معهم على إنزال الدمار بالإسلام والمسلمين.
ولحسن الحظ فإن الغزاة الذين انطلقوا أساساً من نقطة التعصب والمذهبية، مارسوا الطائفية نفسها إزاء رفاقهم في العقيدة ممن ينتمون لأجنحة نصرانية أخرى، بدءاً من البيزنطيين الأرثوذكس، وانتهاء بجل الفئات النصرانية المحلية، ممن لم تدن بالمذهب الكاثوليكي الذي انضوى تحت لوائه معظم الغزاة، ولولا ذلك لامتدت مساحة التعاون بين الطرفين، فيما كان يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر وخامة.
المهم إننا لم نشهد عبر مرحلة الحروب الصليبية هذه بثوراً طائفية، في نسيج المجتمع الإسلامي، كرد فعل لغزو وهو في أساسه ديني متعصب.. لم نسمع بمذبحة ارتكبها المسلمون ضد رفاقهم في الأرض، ولا بعمل انتقامي غير منضبط نفذوه ضد مواطنيهم وأهل ذمتهم!!
وما من شك في أن هذا الانفتاح الذي شهده المجتمع الإسلامي إزاء العناصر غير الإسلامية، والفرص المفتوحة التي منحها إياهم، قاد بعض الفئات ـ كما رأينا ـ إلى ما يمكن عدّه استغلالاً للموقف السمح، ومحاولة لطعن المسلمين في ظهورهم، وتنفيذ محاولات تخريبية على مستوى السلطة حيناً، والعقيدة حيناً، والمجتمع نفسه حيناً ثالثاً، وإننا لنتذكر هنا ـ على سبيل المثال كذلك ـ ما فعلته الطوائف اليهودية بدءاً من محاولات السبئية، وانتهاء بمؤامرة الدونمة لإسقاط الخلافة العثمانية، وما فعلته بعض الطوائف المجوسية في العصر العباسي فيما يشكل العمود الفقري للحركة الشعوبية، التي استهدفت العرب والمسلمين على السواء.
لكن هذه الخسائر التي لحقت بالمسلمين من جراء تعاملهم الإنساني مع مخالفيهم في العقيدة، والمخاطر التي تعرضوا لها عبر تاريخهم الطويل، من قبل هؤلاء الخصوم الذين استغلوا الفرصة، وسعوا إلى ممارسة التخريب والتآمر والالتفاف لا تسوّغ البتة اعتماد صيغ في التعامل غير تلك التي اعتمدها المسلمون في تاريخهم الاجتماعي الطويل .. وتقاليد غير تلك التي منحهم إياها، ورباهم عليها كتاب الله، وسنة رسوله عليه السلام، وتجارب الآباء والأجداد.
إن الخسائر الجزئية ـ مهما كانت فداحتها ـ لأهون بكثير من الخسارة الكبرى ذات البعد الإنساني، وإن الإسلام نفسه - قبل غيره من الأديان- كان سيخسر الكثير لو حاول أن يسعى إلى تحصين نفسه بالحقد والطائفية، والردود المتشنّجة التي تجاوز حدودها المعقولة والمسوّغة.
وإن الإنسان نفسه كان سيغدو الضحية لو أن المجتمع الإسلامي خرج على التقاليد النبيلة المتألقة التي علّمه إياها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه ـ فيما عدا التاريخ الإسلامي ـ فإنه ليس ثمة في تاريخ البشرية ـ قديماً وحديثاً ـ مرحلة كتاريخ الإسلام احترم فيها فكر المخالفين وصينت عقائدهم، وحُميت حقوقهم، بل كانوا ـ على العكس تماماً ـ هدفاً للاستعباد والهوان والضياع، بل التصفية والإفناء.
لم يكن هدف الفتوحات الإسلامية جميعها، منذ عصر الرسول القائد - صلى الله عليه وسلم- وحتى سقوط العثمانيين فرض العقيدة الإسلامية بالقوة كما يتعمد البعض أن يصور أو يتصور.
إنما نشر السيادة والمنهج الإسلامي في العالم , إنها محاولة جادة لتسلم القيادة من الأرباب والطواغيت، وتحويلها إلى أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً.
وتحت ظلال هذه القيادة، كان بمقدور الناس، وقد حُرّروا تماماً من أي ضغط أو تأثير مضاد أن ينتموا للعقيدة التي يشاؤون، ولما كانت عقيدة الإسلام هي الأرقى والأجدر والأكثر انسجاماً مع مطالب الإنسان بأي مقياس من المقاييس، كان من الطبيعي أن تنتشر بين الناس، وأن ينتمي إليها الأفراد والجماعات بالسرعة التي تبدو للوهلة الأولى أمراً محيراً، ولكن بالتوغل في الأمر يتبين مدى منطقية هذا الإقبال السريع الذي يختزل الحيثيات، انتماءً إلى الإسلام وتحققاً بعقيدته.. إنه الجذب الفعّال الذي تملكه هذه العقيدة، والاستجابة الحيوية لحاجات الإنسان في أشدها اعتدالاً وتوازناً وانسجاماً، تلك التي يحققها هذا الدين.
إن سير توماس أرنولد، وهو رجل من الغرب سبق وأن أشرنا إليه، يتفرغ السنين الطوال لمتابعة هذه المسألة، ثم يعلنها في كتابه المعروف (الدعوة إلى الإسلام) بوضوح لا لبس فيه، واستناد علمي على الحقائق وحدها بعيداً عن التأويلات والتحزّبات والميول والأهواء.
ونكتفي هنا ببعض الشهادات التي قدمها هذا الباحث كنماذج تؤكد البعد الإنساني للسلوكية التي اعتمدها الإسلام في الانتشار. يقول الرجل: "يمكننا أن نَحكُم من الصلات الودية التي قامت بين المسيحيين والمسلمين من العرب بأن القوة لم تكن عاملاً حاسماً في تحويل الناس إلى الإسلام , فمحمد نفسه عقد حلفاً مع بعض القبائل المسيحية، وأخذ على عاتقه حمايتهم , ومنحهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، كما أتاح لرجال الكنيسة أن ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمأنينة"(17).
"إن الأخبار الخاصة بزوال المسيحية من بين القبائل العربية النصرانية التي كانت تعيش في بلاد العرب الشمالية، لا تزال بحاجة إلى شيء من التفصيل، والظاهر أنهم قد انتهوا إلى الامتزاج بالمجتمع الإسلامي الذي كان يحيط بهم عن طريق ما يسمونه الاندماج السلمي، والذي تم بطريقة لم يحسسها أحد منهم، ولو أن المسلمين حاولوا إدخالهم في الإسلام بالقوة عندما انضووا بادئ الأمر تحت الحكم الإسلامي، لما كان من الممكن أن يعيش المسيحيون بين ظهرانيهم حتى عصر الخلفاء العباسيين"(18) .
"ومن هذه الأمثلة التي قدمناها عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب المسيحيين في القرن الأول من الهجرة، واستمر في الأجيال المتعاقبة، نستطيع أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة حرة، وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح"(19) .
"لما بلغ الجيش الإسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في فحل، كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولون: "يا معشر العرب أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا , وأرأف بنا , وأكف عن ظلمنا , وأحسن ولاية علينا , ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا" ، وأغلق أهل حمص مدينتهم دون جيوش هرقل، وأبلغوا المسلمين أن ولايتهم أحب إليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم"(20) .
" أما ولايات الدولة البيزنطية التي سرعان ما استولى عليها المسلمون ببسالتهم، فقد وجدت أنها تتمتع بحالة من التسامح لم تعرفها طوال قرون كثيرة، بسبب ما شاع بينهم من الآراء اليعقوبية والنسطورية، فقد سُمح لهم أن يؤدّوا شعائر دينهم دون أن يتعرض لهم أحد، اللهم إلا إذا استثنينا بعض القيود التي فُرضت عليهم منعاً لإثارة أي احتكاك بين أتباع الديانات المتنافسة.
ويمكن الحكم على مدى هذا التسامح ـ الذي يلفت النظر في تاريخ القرن السابع ـ من هذه العهود التي أعطاها العرب لأهالي المدن التي استولوا عليها، وتعهدوا لهم بحماية أرواحهم وممتلكاتهم , وإطلاق الحرية الدينية لهم في مقابل الإذعان ودفع الجزية(21) " وقد زار عمر الأماكن المقدسة يصحبه البطريق، وقيل: إنه بينما كانا في كنيسة القيامة- وقد حان وقت الصلاة- طلب البطريق إلى عمر أن يصلي هناك، ولكنه بعد أن فكر اعتذر وهو يقول: إنه إن فعل ذلك فإن أتباعه قد يدعون فيما بعد أنه محل لعبادة المسلمين"(22) " وكان المسيحيون يؤدون الجزية مع سائر أهل الذمة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين"(23) .
" ولما كان المسيحيون يعيشون في مجتمعاتهم آمنين على حياتهم وممتلكاتهم، ناعمين بمثل هذا التسامح الذي منحهم حرية التفكير الديني، تمتعوا- وخاصة في المدن- بحالة من الرفاهية والرخاء في الأيام الأولى من الخلافة"(24) ، " زار راهب دومنيكاني من فلورنسا ويدعى (Ricoldos de Monre Crucis) بلاد الشرق حوالي نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر، وتحدث عن روح التسامح التي تمتع بها النساطرة إلى عصره في ظل الحكم الإسلامي فقال: "قرأت في التاريخ القديم وفي مؤلفات للعرب موثوق بها أن النساطرة أنفسهم كانوا أصدقاء لمحمد وحلفاء له، وأن محمداً نفسه قد أوصى خلفاءه أن يحرصوا على صداقتهم مع النساطرة، التي يرعاها العرب أنفسهم حتى ذلك اليوم بشيء من العناية"(25) .
وإذا نظرنا إلى التسامح الذي امتد على هذا النحو إلى رعايا المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي، ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق"(26) ، "إننا لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قُصد منه استئصال الدين المسيحي.
ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهباً يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة.
وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالاً تاماً عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف في جانبهم بصفتهم طوائف خارجة عن الدين, ولهذا فإن مجرد بقاء الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم"(27) ، " جلب الفتح الإسلامي إلى الأقباط في مصر حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزمان.
وقد تركهم عمرو أحراراً على أن يدفعوا الجزية، وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية، وخلصهم بذلك؛ من التدخل المستمر الذي عانوا من عبثه الثقيل في ظل الحكم الروماني.. وليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتداد الأقباط عن دينهم ودخولهم في الإسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامح من جانب حكامهم الحديثين, بل لقد تحول كثير من هؤلاء القبط إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح، حين كانت الإسكندرية حاضرة مصر وقتئذ لا تزال تقاوم الفاتحين، وسار كثير من القبط على نهج إخوانهم بعد ذلك بسنين قليلة"(28).
هذه لمحات عن منطقة محدودة فحسب هي العراق والشام، ومصر إلى حد ما، من العالم الذي امتد إليه الإسلام وتعامل معه، فهنالك بلاد فارس وأواسط آسيا، وإفريقية، وأسبانيا، وجنوبي أوروبا وشرقيها، والهند والصين، وجنوب آسيا، مما تحدث عنه أرنولد فأطال الحديث.
--------------------------------------------------------------------------------
الهوامش
(1) أنظر: عماد الدين خليل: دراسة في السيرة، ط15، دار النفائس، بيروت ـ 1997م، الفصلان الثامن والتاسع.
(2) محمد بن سعد ( ت 230 هـ ) كتاب الطبقات الكبرى، تحقيق ادوارد سخاو ورفاقه، مصور عن طبعة ليدن، بريل ـ 1325 هـ ( بدون تاريخ ) 1/2/36، 84 ـ 85، أحمد بن يحيى البلاذري ( ت 279 هـ )، فتوح البلدان، تحقيق صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة، القاهرة 1957 م، 1/76 ـ 78، أحمد بن واضح اليعقوبي ( ت 282 هـ )، تاريخ اليعقوبي، تحقيق محمد صالح بحر العلوم، المكتبة الحيدرية، النجف ـ 1964 م، 2 / 71 ـ 72.
(3) البلاذري: فتوح البلدان 1 / 78.
(4) ابن سعد: الطبقات 1/2/28 ـ 30.
(5) المصدر نفسه 1 / 2 / 38.
(6) عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص 358.
(7) الدعوة إلى الإسلام، ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن ورفاقه، ط3 مكتبة النهضة، القاهرة ـ 1971، ص 79.
(
(9) المرجع نفسه : ص 130.
(10) ينظر المرجع نفسه للإطلاع على المزيد من الشواهد.
(11) حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ط3، دار إحياء الكتب العلمية، القاهرة ـ 1956 م، ص 336.
(12) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ط5، مكتبة دار العروبة، القاهرة ـ 1964 م، ص 29 ـ 30.
(13) المرجع نفسه، ص 36 ـ 37.
(14) وهو الكتاب الرابع من دولة الإسلام في الأندلس، ط2، مطبعة مصر، القاهرة ـ 1958 م.
(15) تاريخ العرب المطول، ط4 ، دار الكشاف ، بيروت ـ 1965 م، 1/ 301 ـ 302.
(16) المرجع نفسه 2 / 432 ـ 438 وينظر : ول ديورنت : قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران وآخرين، ط2 ، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ـ 1964 ـ 1967 م، 13 / 131، وآرثر ستانلي تريتون : أهل الذمة في الإسلام ، ترجمة وتعليق د. حسن حبشي، ط2، دار المعارف، القاهرة ـ 1967 م، ص 170.
(17) الدعوة إلى الإسلام، ص 65.
(18) المرجع نفسه، ص 68.(19) المرجع نفسه، ص 69 ـ 70.
(20) المرجع نفسه، ص 73.
(21) المرجع نفسه، ص 74.
(22) المرجع نفسه، ص 75.
(23) المرجع نفسه، ص 79.
(24) المرجع نفسه، ص 81.
(25) المرجع نفسه، هامش 1 ، ص 81.
(26) المرجع نفسه، ص 88.
(27) المرجع نفسه، ص 98 ـ 99.
(28) المرجع نفسه، ص 123 ـ 124.